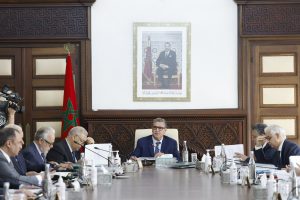إذا كانت الجريمة تقتل فليس من حق العدالة أن تشبهها
رسالة مفتوحة إلى صديق مدافع عن الحكم بالإعدام
عزيزي،
في حمأة التعبير عن استنكارك للجريمة النكراء التي هزت المغاربة قاطبة وذهب ضحيتها الطفل الراحل عدنان في طنجة، خلال شتنبر الحزين لهذه السنة الاستثنائية التي أناخت بكلكلها على ضميرنا الجمعي، كتبتَ على صفحتك بغضب بارز: “أينكم أيها المدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام؟”
لا أخفيك أنني فوجئت لموقفك هذا، ليس فقط لأنك أحد مؤسسي حركة ضمير التي تستند في مرجعياتها لقيم ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، بل فاجأتني كذلك لهجتك التي لم تترك مجالا لنقاش ولا لتبادل عقلاني للحجج، على غير عادتك، مع أنني عهدتك في الصفوف الأمامية يوم طُرحت قضايا كبرى من بينها قضية المرأة في النقاش المجتمعي بداية الألفية، تكتب وتحاجج وترد ولا تحجم، وتبقى مع ذلكَ لطيفا ودُودا رغم كل الهجمات عليك فوق الحزام وتحته.
لذلك اعتبرتُ غضبكَ المفاجئ هذا ناتجا عن بشاعة الجريمة التي تركت فينا جميعا ألما لا يُحد.
أعرف دخيلتك واستقامتك وحبك للآخرين وتفانيك في خدمة بلدك وأعرف إنصاتك للرأي والرأي المخالف، لذلك قررت أن أخاطبك وأناقشك علنا لأنني اعتبرت نفسي من ضمن المعنيين بتدوينتك.
*****
بدءا، موضوع الحكم بالإعدام ما زال يعرف الأخذ والرد ليس في بلادنا فحسب بل في كل بلاد الدنيا على اختلاف مرجعياتها. وحتى في البلدان التي ألغته من ترسانتها، لا زال هناك من يدافع من موقع الأقلية، عن ضرورة العودة للأخذ به، وذلك في احترام تام لحقوقه كرأي أقلية، وهي حقوق لا أطمع في أكثر من التمتع بها إزاءك أيها الصديق.
أناقشك لأنني أعرف أنك لا شك مغيرٌ رأيكَ يوم تقتنع ببراهيني وحججي. وإن لم تقتنع فسوف تستمر في الدفاع عن رأيك بكل استقامة، حريصا على بلورة حججك بطريقة عقلية ومنطقية من وجهة نظرك، ولن يفسد الأمر للود قضية ولن تعاديني بالتالي ولن تهدر دمي ولن تعتبرني من زمرة من يجوز فيهم كل فعل وقول قبيح… علما بأن من يفعل ذلك لا يكشف إلا عجزه، لأنه بالضبط يستند إلى نفس الاعتبارات العدائية والعدوانية، البعيدة عن احترام الحق المقدس للآخرين في إبداء الرأي، فلا تقيم وزنا للآخر إلا بقدر تطابقه مع الرأي السائد في غوغائية لا ترى إلا ذاتها…أولئك الذين لا ينتظرون إلا الفرصة للانقضاض دون ولو حجة واحدة عدا التهم الجاهزة والتهجم والترهيب المعنوي ومحاولة تأليب الناس البسطاء…
أعرف أن الأغلبية في بلادنا – وهي تقارب 60 في المائة حسب ما هو متوفر من معطيات – لا زالت تعتبر أن الحكم بالإعدام مسألة بديهية، بل وواجبة، ومنا منْ يجتهد فيحصر الأمر في الجرائم البشعة مثل ما وقع في طنجة.
غير أن لي يا صديقي رأيا آخر، أظنه ينسجم مع الفكرة التي تشكلت لدي من خلال تجربتي في الحياة. ولذلك فلن يثنيني أي اعتبار عن الجهر برأيي ولو ظللت وحدي أدافع عنه، وأعرف أنني لست وحدي. وحتى لو انفض أصدقاء الفكر أو صمتوا، أعرف أنهم سيتحدثون بعد لحظة الصمت، يوما ما…
في هذه الأمور الجوهرية قل رأيك واتركه للتاريخ ولا تخف في ذلك إلا ضميرك.
*****
عزيزي،
لست في حاجة إلى أن تذكِّرني بألم الفقد حين يعصف بقلب أم مثل أم عدنان. ولا بحاجة إلى تذكيري بظروف وتفاصيل الجريمة المنكرة ولا بمثيلاتها…
لكنني أطمع في صبرك كي أبلغك براهيني بكل الوضوح الممكن.
بدءا أذكرك أن هناك اليوم توجها مطردا عبر العالم لإلغاء عقوبة الإعدام أو التخلي عنها.
فقد سجلت هذه القضية مكاسب كبرى على امتداد السنوات. وعلى عكس الاعتقاد السائد، وبفضل نضال الحقوقيين في العالم، فإن الوضع في العالم اليوم هو كالتالي: من ضمن حوالي 200 دولة عضو في الأمم المتحدة تخلت 106 منها عن حكم الإعدام في جميع الجرائم، فيما ألغته 9 دول في جرائم الحق العام، وتوقفت 29 دولة، عن تنفيذه في الواقع. وبذلك يكون عدد الدول التي ألغت العقوبة في القانون والواقع: 144.
وبالنسبة لإفريقيا، فقد تم الإلغاء في 17 دولة آخرها غينيا في ابريل 2020 والتشاد في نفس التاريخ. وللأسف فإن 86 في المائة من الإعدامات المنفذة سنة 2019 هي بلدان تنتمي لفضائنا القريب: السعودية ومصر والعراق وإيران، وبيلوروسيا في أوروبا. مع تسجيل افتقاد الأرقام الحقيقية لما يحدث في هذا الشأن في الصين.
إن تثميني لهذه الخطوات ليس صدفة كما لا يخفى عليك أيها الصديق. فأنت تعلم أن مناهضتي لحكم الإعدام ليس وليدة اليوم. إنها قديمةٌ وقد كنت كما تعلم عضوا في هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أوصت بعد وقوفها على ظروف السنوات السوداء، بإلغائه من الترسانة القانونية المغربية بالمرة…
إنها ليست وليدة اليوم،
فقد كان صوت “حركة ضمير” من الأصوات المغربية القليلة التي استنكرت تنفيذ حكم الإعدام في إرهابيين مصريين ينتمون إلى صفوف الإسلام السياسي العنيف منذ سنتين أو ثلاث، على الرغم من وقوفي شخصيا ووقوف حركة ضمير على الطرف النقيض لأفعالهم واختياراتهم المجتمعية…
*****
ولنبدأ من البداية لو سمحت…
لقد كان الإعدام في الماضي وإلى وقت قريب، شيئا مفروغا منه. لا يجادل فيه أحد. ولا أي دولة.
غير أننا نتواجد اليوم – كما أسلفتُ – في عالم لا يُعدم أحدٌ في ثلثي دُولِه… منها المغرب الذي توقف فيه تنفيذ الأحكام بالإعدام منذ ما قرابة ثلاثة عقود …
سوف أستمر في عرض رأيي وأنا متيقن من أنك لن تتهمني بأنني أدافع عن المجرمين…
في الماضي كان تنفيذ حكم الإعدام رديفا لإهانة الشخص المدان وإلحاق الأذى به وتعذيبه قبل الإجهاز عليه. وقد أصبح للبشرية توثيق ومتاحف غامرتُ بزيارة أحدها في يوم من الأيام، هو متحف مدينة “براغ” بتشيكيا. كان المتحف في عمارة بها 3 طوابق. وبكل صراحة فإنني لم أفلح في مسعاي. يضم هذا المتحف كل الصور والآلات والتعاليق الممكنة حول تفنن الإنسان في تعذيب أخيه الإنسان بشكل مرعب.
خلاصة القول أنني لم أستطع إتمام الزيارة ورجعت أدراجي، لأنني بكل بساطة أدركت إلى أي مدى يمكن أن يصبح كل فرد منا – نحن كبشر – قادرا على الإبداع في صناعة الجحيم وأسبابه لمن هم أمثالنا في الانتماء إلى البشرية. خرجت من هناك وقد تملكني الغثيانُ من تلك “العبقرية” كلها التي أبدعها بشرٌ مثلي ومثلك، تلك العبقرية التي كانت ترمي إلى إذاقة الفرد المدان بقانون الزمن المعطى داخل الجماعة المعطاة أبشع أنواع التعذيب التي يمكن والتي لا يمكن تصورها شريطة أن تدوم أطول وقت ممكن ليذوق أبشع وأشد عذاب ممكن.
للأسف لم تخلُ حضارةٌ على وجه الأرض من ذلك.
كل الحضارات عرفت هذه الوحشية.
كتبتُ هذه الجملة منذ ثوانٍ وانتبهتُ إلى هذه المفارقة الغريبة: أن أتحدث عن الحضارة وأردفها بالوحشية…
كل الشعوب على اختلاف أنماط عيشها وأشكال تدينها ومناطق تواجدها الجغرافي عرفت هذا “الإبداع” الهمجي.
من يقرأ كتاب “المراقبة والعقاب” (Surveiller et punir) لميشيل فوكو، بإمكانه أن يطلع طوال ثلاث صفحات بالتمام والكمال على تفاصيل التعذيب المُروع الذي سبق إعدام “دميان” (Damien) المتهم والمُدان في جريمة محاولة اغتيال الملك لويس الخامس عشر بفرنسا بباريس شهر مارس 1757.
تصورْ حيثياتِ الحكم ثم تصورْ تفاصيل تنفيذه كما تشهد على ذلك الوثائق القضائية الموجودة في أرشيف فرنسا. وإليكَ الحُكم الصادر في حقه بالتفاصيل:
“أن يأتوا ب(Damien) عاريا محمولا على عربة قابلة لرمي حمولتها على الأرض، وليس على جسده إلا قميص، ممسكا بشعلة من الشمع الملتهب. ثم يوضع على سقالة (échafaud). وبواسطة كماشة (tenailles) سوف يتم قضم ضِرعيه (mamelles) ثم ذراعيه ثم فخذيه حيث اللحم مكتنز وسوف يمسك بالخنجر أداة الجريمة الذي حاول به قتل الملك ويتم إحراق اليد بلهيب الكبريت ويتم رش الرصاص المنصهر والزيت الملتهب والشمع الذائب معا فوق الجروح التي أحدثتها الكماشة في جسمه. ثم يتم ربط أطرافه الأربعة (يديه ورجليه) بأربعة أحصنة كل في اتجاه ويتم جره بعنف حتى تنقطع أوصاله، ثم يتم إحراق بقاياه حتى تصير رمادا” (الصفحة 9 من الكتاب وما يليها – الترجمة من عندي)
لن أسرد عليك ما جرى تطبيقا لهذا الحكم. أترك لك تصور الأمر، علما بأن دميان هذا كان قوي البنية، فلم يسلمِ الروحَ إلا بعد عذاب لا مثيل له، حيث لم تستطع الأحصنة الأربعة أن تقطع أوصاله فقام الجلادون بهذا الدور بواسطة خناجر حادة البتر.
أرى فكرة قد تتراءى عند هذا الحد للقارئ: “نحن في منأى عن هذه البشاعات. فليس هذا في تاريخنا…”.
مهلا. سيدي. مهلا…
بل فيه وأكثر…
يورد هادي العلوي في كتابه “فصول من تاريخ الإسلام السياسي” (الطبعة الثانية 1999. عن دار مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي): الصفحة 295 وما يليها، أساليب القتل المسبوقة بالتعذيب والتمثيل بالأجساد في حالات عديدة ويسرد منها التشميس (أن يوضع المرء في الشمس في عنفوانها بعد إلباسه درعا من حديد)، وحمل الرؤوس المقطوعة وتقطيع الأوصال وسلخ الجلود و الحرق والقتل بالطشت المحمى والموت بالنورة المؤدي للاختناق بعد وضع الرأس في كيس والتعطيش وإخراج الروح من طريق آخر… الخ الخ…
أما في روما فقد كان التعذيب شيئا طبيعيا قبل الإجهاز على المحكوم بالموت، بل كان يُسمح للأشخاص بتعذيب المدينين لهم بالمال (ص 24 من كتاب “تاريخ التعذيب” – براين اينز – الدار العربية للعلوم – 2000). وكان يتم تنفيذ حكم الإعدام بحرق المتهم حيا (ص 26).
وفي المغرب فإن عقوبة الإعدام قديما كانت تنتمي إلى منظومة العقوبات الجسدية التي كان معمولا بها في بلادنا والتي تخلى عنها المغرب طبقا لترسانته القانونية بعد الاستقلال (مثل قطع اليد والرأس، والرجم في حالات نادرة…) . مع تسجيل أعراف وتقاليد مغايرة تماما عُرفت في المناطق الخارجة عن الحكم المركزي. ففي مقال صدر أخيرا بعنوان “عقوبة الإعدام تتعارض مع القيم الأصيلة للشعب المغربي”، يورد الأستاذ الباحث أحمد عصيد معطياتٍ موثقةً عن غياب “العقوبات الجسدية مطلقا (…) [في المناطق الأمازيغية] وتعويضها (…) بالغرامات، كما لا تتضمن عقوبة القتل والإعدام بقدر ما تنصّ على النفي من القبيلة (أزواك Azwag) وهو أقصى حكم وأقساه لديها.
أنت ترى أن البشر بلا استثناء عرفوا كل هذه الأشكال.
وما يثير الفزع، صديقي العزيز، هو أن هذه الأشكال من التعذيب قبل القتل كان يحضرها أناس مثلي ومثلك بالمئات والآلاف وهؤلاء الذين عذبوا دميان والآلاف الذين حضروا قتله البطيء كانوا بشرا مثلي ومثلك…
ها هنا أسأل نفسي وأسألك: قد يبدو لنا الأمر هامشيا، لكنني أسألك مع ذلك: هل كنت تقبل شخصيا أن تزهق روح أحد ولو تطبيقا لحكم صادر عن محكمة؟ جوابك يهمني. إذ أن القبول بمهمة السياف مسألة ليست بالسهلة ولا الهينة… أما جوابك ب”لا” فهو جواب في الموضوع لا في الشكل…
خذ لك أمثلة أخرى.
يقول “براين أينز” هذا أن أغلب الجلادين تحت الحكم الروماني لم يكونوا متطوعين بل كان معظمهم من الأسرى والمجرمين. وكانت القسوة بحيث أن القنصل الروماني كوينوس الذي كان ينوي ترتيب حفلة تعذيب بواسطة الحيوانات المفترسة على شرف نجله، وجد أن المساجين قد خنقوا بعضهم البعض حتى لا تأكلهم الوحوش.
الأزتيك والهنود الأمريكيون والإغريق ومحاكم التفتيش الكاثوليكية والدول الإسلامية المتعاقبة والصليبيون وعدد من الباباوات أشهرهم إينوسانت سنة 1252 والاستعمار في المستعمرات: كلها عرفت التعذيب والتمثيل بالجسد قبل تنفيذ الإعدام، أو قطع الرؤوس وعرضها بعد التمثيل بأجساد أصحابها كما كان يفعل الاستعمار الفرنسي والاسباني بأبناء المغرب الثائرين عليه …
قد تتساءل عند هذا الحد عن العلاقة بين التعذيب والقتل. ولا أقول الموت، إذِ الموتُ عموما هو توقف للوظائف الرئيسية للجسد أو لإحداها. أما التعذيب فهو الباب المشرع على امتهان الجسد وسقوط حرمته. هو عنوان اضمحلال التضاريس التي تصنع الهيكل الذي يجعلنا نقف وندب على الأرض، هو الصرح المادي حيث تتجسد كينونتنا. هل رأيت شخصا بلا جسد؟ لا طبعا…
التعذيب هو كثافة الخبث الشيطاني في أجلى صوره المتوحشة، لأن منفذه يعرف بالضبط – باعتبار أن له جسدا – يعرف أين توجد مكامن الإيلام وكيف يتكثف الأذى. إن التعذيب هو انطباع السلطة الغاشمة على جسد أعزل. والمثير في الأمر أنه إلى ذلكَ، عنوانٌ على طاقة البطش الكامنة في كل واحد منا والتي لا تحدها إلا الأخلاق والتهذيب والقيم ثم القانون والمؤسسات وآليات الردع…
والقتل – أو الإعدام إن أردتَ – هو ذروة هذا المنطق وقمته، ما عدا في حالة الدفاع عن النفس. القتل هنا بكل مسمياته، بما فيها الإعدام، هو قمة امتهان الجسد إياه. إنه تعبير، في العمق، عن التطاول على الحياة.
قد تردُّ على كلامي بأن المجرم فعلَ مثل ذلك بالضبط، ولذلك فهو يستحق نفس المعاملة.
قد يكون هذا المنطق مقنعا في شكله الصوري، التماثلي.
لكنني أجيبك: نحن، بالمقابل، نستحق ألا نتبنى نفس المنطق كي نقتل القاتل، كي نبرر قتله. كي نزهق روحه. نستحق أن نعاقبه العقاب الذي يجنبنا التفريط في إنسانيتنا كما فرط فيها هو. لأنه يمثل نفسه الآثمة. أما نحن فمن المفروض أن نتحدث باسم مصلحة المجتمع. أقول ذلك وأنا مقتنع بأن إنسانية كل شخص – بما في ذلك أنا وأنت – ليست معطى لا تشوبه الشوائب والهِنات، مما يجعل كل واحد منا مسؤولا عن الانتباه إلى ديمومة حسه الإنساني واستمراره…
*****
ولنناقش الآن – لو سمحت – مبررات اعتماد الحكم بالإعدام…
ما هي مبررات الحكم بالإعدام؟
- ردع مجرمين آخرين محتملين
- إنزال العقاب بالمجرم
- إشفاء غليل عائلة الضحية
- حماية المجتمع من الجريمة وإقرار العدل.
الجواب على المبرر 1: لم يثبت لحد اليوم أن الحكم بالإعدام في أي مجتمع يشكل رادعا للجريمة، بل هناك بلدان قامت بإلغائه فتراجعت الجريمة…
الجواب على المبرر 2: نعم للعقاب، لكن كيف تعاقب من أنت تلغيه؟
الجواب على المبرر 3: هذا منطق العين بالعين، يعود إلى حمورابي منذ آلاف السنين
الجواب على المبرر 4: نعم. عين الصواب، وهنا يجب أن تتقدم الوقاية على العلاج.
يجب أن نوضح قبل كل شيء ما الهدف من إقرار العدل على وجه العموم.
لقد عرفت المجتمعات البشرية – في مواجهتها للخارجين عن القانون القائم – مبدأ العين بالعين والسن بالسن أجيالا وقرونا بل وسُنَّت القوانين وفقَ هذا المبدأ.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي بالضبط: هل استطاع هذا المبدأ أن يشكل أساسا لاستتباب العدل؟ وهل مبدأ السن بالسن يمكن أن يقيم العدل فعلا أم أن على البشرية أن تختار منطقا آخر؟
إن هذا المبدأ ينجح فعلا، لكن فقط في إشفاء غليل الضحية أو أهله. أما المجتمع فيبقى متفرجا في انتظار جريمة أخرى. والحال أن الأمر يتعلق بحماية المجتمع وأفراده بالأساس. وعليه، فإذا أقررنا بأن الأمر يجب أن يكون على هذا النحو، فإن الموضوع يتغير من أساسه. إذ تصبح الألوية هي ضمان الأمن والأمان والسلامة للجميع وبالتالي وضع النظام العقابي الذي يضمن ذلك.
والأمر لا يتوقف عند النظام العقابي بل يتعداه إلى النظام الحمائي في الأصل.
ويطرح الموضوع باستعجال أكبر حين يتعلق بالجرائم العنيفة والشنيعة. وهنا مربط فرسنا اليوم، غداة اغتصاب واغتيال الراحل عدنان.
لا يختلف اثنان في أن الفتك بشخص عبر إخضاعه لسلب حياتهِ جريمةٌ لا تُغتفر. عملٌ يناقض فطرة الحياة وينتهك حقا مقدسا لكل الآدميين. أتحدث هنا طبعا عن أعمال المجرمين الذين يفتكون بضحاياهم ولا يستحقون إلا الإدانة مهما كانت مبرراتهم، باعتبارهم – لحظةَ الجريمة – مصدرا للشر في أجلى تجلياته…
لكنني يمكن أن أتساءل عن طبيعة الجواب المطلوب على جريمة من هذا الصنف… أي عن مبدأ إخضاع المجرم لعقاب من نفس نوع جريمته: يعني القتل…
ما الذي يعنيه إعدامي إياه؟
إعطاء المثل؟ ليس هناك أبلغ من سلب حرية المجرم على مدى الشهور والسنوات والعقود…
إشفاء غليل الضحايا؟ هي لحظة ثم تضمحل…
حماية المجتمع؟ لا. فالحكم بالإعدام لم يوقف الجريمة في أي مكان…
ثم إن تنفيذ حكم الإعدام – باعتباره سلبا للحياة – في شخص تحت رحمتك، وعلى الرغم من النوايا النبيلة التي قد يحملها المدافعون عنه، لا يختلف أخلاقيا عن سلب الحياة في أي وضع آخر للأسف.
إن المطالبات الغاضبة بالقصاص، بكل تفاصيلها التنكيلية – وبسببها بالضبط – تجعلها أقرب إلى التنفيس عن الغضب والتعبير عن الخوف، من استشراف الحلول للمستقبل والمجتمع.
إن عقوبة الإعدام ما هي إلا حل زائف ومريح لكسلنا الفكري والوجداني تجاه مسؤولياتنا الفردية إزاء معضلات من هذا النوع. وهو كذلك تهرب من تحليل أسباب الجريمة ودوافعها…
*****
صديقي العزيز،
ها نحن نقترب من الموضوع الجوهري: حماية الأفراد المجتمع. فإذا اتفقنا على أولوية حماية الأفراد والمجتمع في أسس سياساتنا الجنائية، يصبح الطريق سالكا أمام الحلول.
من هذه الزاوية إذن ، من حق المجتمع أن يحمي نفسه بالطريقة المثلى:
- بإبطال أذى المجرم عن طريق العقاب بسلبه حريته لآماد طويلة غير قابلة للتخفيض الأوتوماتيكي أو العفو (peine incompressible). وللذين يستسهلون الحرمان من الحرية، لا أتمنى لهم يوما واحدا وراء القضبان، أما الذين يستكثرون الأكل والمأوى على السجناء ويفضلون إعدامهم عوض ذلك، فلا تعليق لي على هكذا تفكير…
- بوضع سياسات جنائية ترتكز على الدراسات المستمرة لتحولات المجتمع وأنواع الجريمة به، وربما تكون جريمة طنجة منطلقا لإنشاء المرصد الوطني لمكافحة الجريمة الذي يراوح مكانه منذ الخطاب الملكي سنة 2009، حيث تعاقب على وزارة العدل وزراء كثيرون بعد وفاة الراحل محمد بوزوبع.
إن إقدامنا على إنزال الموت بأي مجرم عقابا له – ولو طبقا لقانون قائم – لا يجوز أخلاقيا، ليس لأن المجرم لا يستحق أشنع الإدانات المعنوية وأشد العقوبات الحبسية نظير فعله اللإنساني البشع، بل لأننا مسؤولون كذلك على الحفاظ على إنسانيتنا، كما سبق أن قلت، ونحن نشارك في الحفاظ على حياة الناس وأمنهم وسكينتهم وحقهم في السعادة الدنيوية ما داموا على قيد الحياة…
إن كل جمهرةٍ هلامية حانقة على جريمة ما، يمكن أن تضم كل واحد منا كمحتجّين بِنيَّة حسنة وهُمُ الأغلبية، كما قد تضم مجرمين يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، أو مشاريع مجرمين في ارتكاب جريمة الاغتصاب لو توفرت لهم ظروفها على الفور. لذلك فإنني – إلى جانب ممارسة حقي في إبداء الرأي بشأن هذا الموضوع المختلف حوله، أسُوق خاطرة لبول ريكور حيث يقول ما معناه:” أعتقد إلى حد ما أن الله نادرا ما يرى أكبر الخطايا في الإساءات إلى القانون: بل هو يراها في شح المودة، وفي أشكال الظلم الفادح، وفي الطريقة التي يمكن بها تدمير حياة الآخرين عن طريق الصمت، والإهمال (…). إن هذا غالبا ما يكون أكثر خطورة من بعض الجرائم التي ربما تكون نتيجة لذنوب الآخرين. من جهتي سأبحث عن الخطيئة (…) في التوجه الانتقامي للجمهور الذي يطالب بالرؤوس، لأنه في أعماقه يتطهر من شعوره بالذنب من خلال إلصاقه بآخرين. يمكننا أن نقول بطريقة ما أن المجرم يجسّد خطيئة الجميع”.
******
عزيزي،
نصل الآن إلى موضوع اغتصاب الأطفال الذي يشكل جوهر المشكل في الواقع. والذي يجب ألا يحجبه نقاشنا عن الحكم بالإعدام. وهو بيت القصيد والخوض فيه واقتراح السبل الكفيلة بتجاوزه وإلا سيكون كل حديثنا أعلاه لغوا لا طائل من ورائه.
*****
هناك معضلة حقيقية تجعل أطفالنا، ذكورا وإناثا، عرضة سهلة ولقمة سائغة للذئاب المتربصة بأجسادهم الغضة ونفسيتهم الهشة.
أهم هذه الأسباب:
- استسهال شأن التنشئة النفسية للأطفال وترك الحبل على الغارب في أغلب الحالات، لا من جانب الأسر ولا من جانب المدرسة،
- تفشي مفهوم “الحشومة” الرائج في كل الأوساط الاجتماعية، وهو ما يمنع الطفل من الشكوى من ممارسات التحرش والاغتصاب المحتملة،
- التكتم على حالات الاغتصاب من طرف عدد من الأسر باسم “الشرف”…
- التنازل عن حق الطفل المغتصب في الانتصاف مقابل منفعة ما لوالديه أو أحدهما،
- الاستعمال العشوائي للوسائط التواصلية غير المراقبة من طرف الوالدين مما يسهل اصطياد الضحايا بين الأطفال واليافعين القاصرين،
- الغياب المطلق لأية تربية جنسية تتوخى تحصين الجسد من كل عبث من طرف غرباء كانوا أم أقرباء.
إن الخطوات العاجلة المطلوبة اليوم تتمثل والحالة هذه في:
- اعتماد وإقرار تربية جنسية تتكامل فيها المدرسة والأسرة، في عدد من الأسلاك التربوية،
- الانضمام إلى الشبكة الدولية لمناهضة البيدوفيليا،
- القيام بحملات تحسيسية دورية عن طريق الإعلام ودور الشباب ودور الثقافة،
- الإسراع بإحداث المرصد الوطني لمكافحة الجريمة،
- إحداث آليات مركزية وجهوية وإقليمية ومحلية للإنذار المبكر،
- التفاعل الفوري مع شكايات الأسر،
- إدراج أقسى العقوبات الحبسية غير القابلة للاستفادة من العفو، ليس فقط في جرائم الاغتصاب المقرونة بالقتل، بل وكذلك في حالات الاغتصاب والتحرش،
- النهوض بالطب النفسي كجزء أساسي في الآليات المتعددة: القانونية والإعلامية والتربوية للوقاية من ظاهرة الاعتداءات الجنسية.
عزيزي،
هذه مشاركة في النقاش موجهة لك، أيها الصديق، بعد أن تراجع منسوب الغضب، وهي موجهةٌ كذلك إلى كل مواطن يشبهك، أي قادر على التعبير عن رأيه مع احترام الآراء المخالفة. وطبيعي أن أسمع منك ومنهم شريطة أن يكون النقاش متوجها للأفكار لا الأشخاص، نقاش يستعمل الحجة المنطقية لا الاتهام المجاني، وشريطة أن نعرف من المتكلم، حتى نكون متساوين أمام الحقيقة.
الخيط رفيع يا صديقي بين العقاب وحفظ المجتمع من جهة وبين الانتقام والتشفي.
على كل منا أن يحدد ما يريد من إنزال العقاب: حماية المجتمع أو التشفي والانتقام. ولنعترف – نحن الضعفاء تحت الله – أن الخيط رفيع بين الاختيارين. ودليل ذلك أن يسألك شخص :” تصور أنه ابنك أو قريبك…” ليثير فيك ميلا فطريا نحو الانتقام والحال أن الأمر لا يتعلق بذلك حين يتعلق بالمجتمع.
على الرغم من “مشروعية” الرغبة في الانتقام، وهو شعور إنساني طبيعي عند الصدمة، لا يمكن أن نروم العدل ونحن نستعمل أدوات مثيلة لأدوات المجرم.
إن قدرنا هو أن نجازف بإنسانيتنا من أجل إنقاذها من التماثل مع فعل الجاني.
إننا مسؤولون عن الحفاظ عليها ، بل وإنقاذ إنسانية المجرم حتى ولو لم يتبق منها سوى قلامة ظفر…
لا يمكن للعدالة أن تتأسس على نفس منطق الجريمة…
*****
كلمة أخيرة إلى من يعتبر هذه الجريمة ومثيلاتها نتيجة ل”استشراء” حقوق الإنسان بين ظهرانينا…
إن من يستكثر علينا هذه الحقوق – ما حققناه منها وما لا يزال ينتظر – عليه، كي يضمن لموقفه كامل الانسجام، أن يتنازل عنها شخصيا بكل وضوح، أي أن يعبر عن رفضه للتمتع بحقوقه كلها: المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها كثير…
لست آمل ذلك لأن حقوق الإنسان لا قيمة لها إلا في كَوْنِيتها وفي عدم قابليتها للتجزيء…
مع المودة التي تعرف.